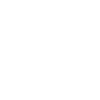( أنت رقم )

درجاتٌ علميةٌ تكادُ تَفيضُ على جَنَباتِ الرّفوفِ في أرجاءِ الْمعمورة الْعربيةِ، وألقابُ مملكةٍ في مَوضِعِها حيناً وفي غير موضعها أحياناً كثيرةً، وما هذا كلَّه إلا لأنّ الرّقمَ يُحاصِرُنا فالسّعي في طلبِ الدّرجةِ الْعلميّةِ واجتيازِ متطلباتها هو الْهدفُ الذي يكون حاضراً في النّفس قَبلَ ولوج المؤسسةِ التّعليميةِ، ويَبقى يَنمو ويزدهرُ حتى بلوغِ أقصاها هدفاً أي "د".
وهذه الإشارةُ في غاية الحساسيّة، إذ إن الاتكاء على فكرة الدّرجة العلمية مفرغةً مِنْ مَضْمونِها من أَجلِ السّعي في مَناكبِ الأرضِ هو أمرٌ متيسّر للجميعِ ولكنّ الانفتاحَ والتّداخلَ الاتصالي أعطى سيولةً في التّواصل بينَ النّاس وحاجةً إلى أن نَكون على مُستوى السّرعةِ الْمُتعِبة التي يلزمكَ لِكَي تُواكبَ بَعْضَها أن تُدركَ أنّك تُشْبِهُ مَنْ يَركضُ على الْجليد، فَنجاتُكَ في سُرعتِكَ حتى تكونَ في مَأْمَنٍ من التّأخّر، ولكن يتأبّى النّظامُ التّعليمي الْعربي في بعض الْبلدان أن لا يكون على مُستوى الْعالَم، وذلك بأن يُعامِلَكَ بِفَرْقعاتِ التّحضر التّعليمي ومواكبةِ العالم من خلال الحوسبة، و "الكندشة" ومعركةِ الْمَناهجِ التي نُحاربُ بِها طَواحين الْهواء، ويُغمض عَينيه عَنْ قيمةِ الْمعرفةِ في كَونها أَداةً للحُريةِ التي يَتمُّ وأْدُها في أوّل تَصْنيفٍ للطّلبة قَائِم على "الرّقم" .
| الإنسانُ كِيانٌ مُتداخلُ المهاراتِ والرّغباتِ والرّؤى والطّموح والأبعادِ والْميولِ وكُلّها تَنهلُ مِنْ خِلال التّجربةِ والخطأ ومِنْ خلالِ الانْطلاق والاشتباكِ مع الطّبيعةِ |
ولا بُدّ مِنْ مُلاحظةٍ مركزيةٍ بأنّك عند أوّل يوم تَدخلُ فيه أيَّ سِجنٍ على سَطح الْكوكَبِ فإنّ أوّلَ شُعورٍ يَجْعلك تَعيشهُ أن تَكون عَدماً؛ أي أن تَكون رَقماً، فالسّجينُ لا اسم يُميّزُهُ ولا هُويةَ واضحةً يَتَفرّدُ بها بينَ أَقْرانِهِ ولا طُموحَ لَهُ يَتناسَبُ مع قُدُراتِهِ بَلْ طُموحاً يَتَناسَبُ مع الْقائمين على النّظم التّعليميةِ ولا قيمةً فعليةً؛ بل الأمرُ بِرمّتِهِ عبارةً عن رَقَمٍ ، وهكذا فأنتَ مجرّد رقم فالّذي يُحصّلُ على 90% فهو مُتميزٌ في كلّ شيءٍ، والّذي يُحصّلُ 70% فهو مُتوسّطُ القدرات والذي لم تُسْعِفُهُ أَدواتُهُ ويحصّلَ أقلَ مِنْ 60% فهو أقل من أن يَكونَ لَهُ طُموحٌ يُزاحِمُ بِهِ مَناكِبَ الأَقرانِ في الْمُسْتَقبَلِ.
وهنا تَكْمُنُ خُطورةُ الأَمرِ أن تُلغى كلّ مَهاراتِكَ وكِفاياتِكَ العلميّةِ والأدبيّةِ والرّياضيّةِ والفنّيّةِ وتُختَصرَ في أن تَكونَ رَقَمَاً لا يُقدّمُ ولا يُؤخّر إن لم يكن ضمن مقاييسهم؛ أي الذين وضعوا هذه المقاييس الْتي تَحمِلُ عَنْهم إصْرَ النّظرِ في الْقدراتِ والْمهاراتِ للأفرادِ حتى لَو كانَ التّحصيلُ الأَكاديميّ مُتواضعاً فإنّ الكِفاياتِ الأُخرى كَفيلةً أن تسدَّ مَسدّ التّدني الأكاديمي، بل وقادرة على أنّ تَجعل صاحِبَها يُزاحِمُ الْمُتفوقينَ أكاديميّاً بالمناكبِ في مَناحي الْحياةِ.
فالطالبُ في الْمدارسِ يَنْهَدُ اثني عَشَرَ سَنةً لِخمسةِ أيامٍ في الأسبوعِ بواقع سِتِّ ساعاتٍ يَومياً لِكي يُحْكَمَ عَليْهِ مِنْ خِلالِ امتحانٍ لِساعَتينِ حَولَ بَعضِ الْمعارفِ الْواقعةِ تَحْتَ مِزاجِ مُتخصصٍ في حَقْلٍ مِنْ حُقولِ الْمعرفةِ لِيُحددَ لَه مستقبَله الْمهني؟؟
الإنسانُ كِيانٌ مُتداخلُ المهاراتِ والرّغباتِ والرّؤى والطّموح والأبعادِ والْميولِ وكُلّها تَنهلُ مِنْ خِلال التّجربةِ والخطأ ومِنْ خلالِ الانْطلاق والاشتباكِ مع الطّبيعةِ والْكون ومَوجوداتِهِ، ويتم هذا بالتركيزِ على الإنسان في داخلنا ذاكَ الذي يأنسُ بالآخرينَ ويأنسُ الآخرون بِهِ مُتّكئِينَ في طَريقنا على أن يتقصّى الطّالبُ الْمعرفة ويَنظرُ في المعلومة، ويَسْبِرَ غَورَها حَتى يُحصّلها لا أن تنزلَ عَليهِ مُعلّبةً، وعلى حد تَعبير باولو فرايري - وهو يعلّم المقهورين في إحدى قرى البرازيل - أن ننتقل بالطّلابِ من التّعليم البنكي الْقائِم على إيداعِ الْمعلوماتِ في رأْسِ الطّالبِ في الْحصةِ، و ونَسترجِعُها مِنه عِندَ الامْتِحانِ، فَنطوي صَفحةَ الْمعلومةِ، ونَختمُ عليها بالْعلامة التي حصّلته لا التي حصّلها إلى التّعليم الْحواري الذي يَبني الْعقل ويُؤسس للمعرفةِ على أرضٍ صَلْدَةٍ.